الفصل الثاني: إهدار موهبة، الجزء الرابع
مئات الناس كانوا يتحركون من حولي، كلهم في عَجَلة أكثر مني—تيار من البشر يتدفق تحت أضواء الشاشات المتعددة الألوان ولافتات النيّون المعلقة على ناطحات السحاب على جانبي الممر.
قلّبت كلمات جايس في رأسي، وحاولت أن أسمح لها أن تجعلني أشعر بتحسن، لكنني ظللت أعلق عند آخر ما قاله عن سيث: سيث هو الشخص الذي جعلته الدنيا هكذا.
هذا الكلام استقرّ في جوفي بشكل مزعج. التوى داخلي. ومع ذلك، لم أستطع إنكار حقيقته، ذاك الواقع القبيح. كنا نعيش في عصر لم يعد فيه هذا العالم ملكًا لنا بالكامل، ولم نكد نفهم الغزاة. كان على الناس أن يتكيفوا، وأن يفعلوا ذلك بسرعة. ربما، كي أنجو أنا أيضًا، عليّ أن أصبح الشخص الذي يريده العالم.
هبط بصري ثانية إلى يديّ المتسختين الملطختين بالدم. انقبضتا في قبضتين. عيناي المثقلتان اللاذعتان أطبقتا. لم أستطع منع نفسي من التساؤل إن كان لسيث وجهة نظر، وإن كنت، ربما، أتصرف برعونة وعنـاد.
رغم الساعات التي لا ترحم، والطاقة الإبداعية الهائلة التي سكبتها في صَنْع العظام—وفي أن أُؤخَذ على محمل الجد كصانع عظام—ربما لم يكن مكاني في الصدوع بعد كل شيء. ربما كانت هذه الترقية العَرَضية، في حقيقتها، دليلًا على أن سيث كان محقًّا. الرئيس فاليرا لم يهتم بأن هذه الترقية الارتجالية قد تودي بحياتي.
فتحت عيني وعاودت المشي. ربما عليّ فقط أن أنكس رأسي وأعرف «مكاني»…
«مكاننا…»
الكلمات عادت من أعماق السنين على غفلة، لتسقط بي في تلك الحلقة من الكراسي غير المريحة. «مكاننا هو تمامًا حيث نحن. هكذا بدأت الحضارة! مع مجموعة من… من الناس العاديين».
الطريقة التي تعثر بها الرجل الذي يقود مجموعة الدعم في كلماته ظلت عالقة في ذهني أكثر من الكلمات نفسها. إن كنت قد تعلمت شيئًا من مخالطة ريدز آخرين، فهو أن لا أحد منهم صدّق هراء «نحن بنفس الجودة لكن بطريقتنا الخاصة».
اعرف مكانك…
هذه الفكرة أغضبتني. بدل أن أغوص في الشفقة، فضّلت أن أحرق غضبي كوقود لكل تلك الليالي المتأخرة والصباحات الباكرة التي أقضيها في العمل. كان عليّ أن أفعل ذلك. من دون رادن، كنت بحاجة إلى عناد، وإبداع، وإحساس مشتعل بالغاية. كنت سأصنع شيئًا يغيّر هذا العالم. شيئًا عبقريًا. شيئًا لا نظير له، ولا غنى عنه.
بين شهيقٍ وآخر، ابتلع الإرهاق غضبي. دم الفيلغيتر اليابس كان يتقشّر عن جلدي، تاركًا إيّاه خامًّا محمرًّا، وملابسي الممزقة بدأت تحتكّ بجسدي وتؤذيه.
بعد أول عشر دقائق تقريبًا، لم يعد مشواري المنفرد يشعرني بالتحرر كما تخيلت، لكنني واصلت السير إلى أن وصلت إلى الأبواب الدوّارة للبرج السكني الشاهق الذي أسميه بيتًا. أملت رأسي إلى الخلف وحدّقت في مانع الصواعق في القمة: ضوء أحمر وحيد ومض للحظات في سماء الليل.
شدّدت عزيمتي، وعبرت الأبواب الدوّارة، واجتزت البهو، متجاوزًا صفوف صناديق البريد العديدة على الجدار الأيمن، متجهًا إلى صفّ المصاعد في الخلف. تجاهلت موظفة الاستقبال خلف المكتب الرئيسي، التي تجعّد أنفها اشمئزازًا من منظري، وضغطت الزر.
كنت واعيًا أكثر من اللازم بمدى سوء رائحتي بعد ساعات من المشي.
لحسن الحظ، كانت الساعة متأخرة، والمصعد الذي انفتح كان خاليًا. ما إن أغلقت الأبواب وبدأ المحرّك يئنّ حتى أسندت ظهري إلى الجدار الخلفي وأغمضت عيني. صدري انقبض من التوتر، وعقدة قاسية في عنقي رفضت أن ترتخي.
بسرعة أكبر مما أردت، تباطأ المصعد وتوقف. تقدمت نحو الباب الثالث على اليسار.
اللعنة. تركت حقيبتي، والمفاتيح داخلها، في جيب سيث.
قبل أن أطرق، انفتح باب الشقة بعنف. هانا، زوجة سيث، وقفت في المدخل لشقتنا المشتركة، حاجباها معقودان بالقلق. كانت تحتضن بطنها الحامل الثقيلة بيد، وباليد الأخرى تمسك مقبض الباب بينما تتفحص وجهي.
قالت: «تعرف، خمس دقائق زيادة وكنت راح تتحمل ذنب إجبار وحدة حامل إنها تتهادى في الشوارع بالليل تدور عليك». التقطت نفحة من رائحتي فغيّرت ملامحها. «مع أني أرجّح كان راح يكون سهل أشمّك من أول زاوية».
قلت: «آسف». هبطت كتفاي، وارتسمت على وجهي ابتسامة باهتة. «ما كان لازم تسهري عشان تنتظريني».
قالت وهي تهز رأسها بحكمة مصطنعة: «اعتذارك مقبول»، وتنحّت جانبًا.
قطّ برتقالي سمين هرول في الردهة وأنا أدخل، ودسّ نفسه بين ساقَيَّ، يحتكّ بكاحلي وهو يشم بقع الدم على بنطالي. التقطته إلى ذراعي، فراح يخرخر وهو يلعق بقايا الدم اليابس على كمّي.
«مايلو، بطّل تاكل قميصي. هذا مقرف».
قالت هانا وهي تغلق الباب خلفي: «سويت لك عشا. بارد، بس أحسن من لا شيء. أعرف إنك على الأغلب ما أكلت شيء طول اليوم».
تقدمت متثاقلة في الردهة، ويدها على أسفل ظهرها، وتبعتها إلى المطبخ. ضوء أزرق خافت كان يرفرف على الأرض المظلمة ونحن نمر بغرفة المعيشة، ولمحت آخر لقطة من نشرة أخبار صامتة عن المسلّة التي تُبنى حول الصدع الذي خرجنا منه أنا وسيث هذا المساء. توقفت، ويدي في جيبي، أراقب المقطع المسجل للسقالات وهي تُنصب في وضح النهار، لكن الشاشة انتقلت سريعًا إلى إعلان.
انضممت إلى هانا في المطبخ بينما صفّارة إبريق الشاي تعلو. التقطت مِمسكَة الحرارة من على المنضدة ورفعت الإبريق عن شعلة الغاز، وسكبت الماء المغلي في فنجان بسيط مزين برسمة زهر كرز على جانبه. تصاعد شذى الياسمين مع البخار.
قفز مايلو من بين ذراعيّ، وهبط بخفة على الأرض، ثم هرول نحو وعاء طعامه عند الجدار.
قلت: «هانا، اجلسي. ما المفروض تبقي واقفة».
ضمت شفتيها ولوّحت بيدها مستخفّة بقلقي. «أقدر أرفع إبريق شاي، يا تورين. لو إنت قلق جدًا، خذ طبقك من الثلاجة وسخّنه بنفسك».
«ما لي نفس آكل»، كذبت.
رفعت حاجبًا. «وأنت ما تقول هذا بس لأنك ناوي تهرب على السرير وتتجنب مواجهة مع سيث بخصوص اللي صار اليوم؟»
شعرت بحرارة تتسلل إلى أذنيّ. «سمعتي؟»
«إيه، سمعت، مع أني مش متأكدة إذا المفروض أبارك لك ولا أعزيك».
«أو بس توبخيني زي ما سيث وبّخ مؤخرتي».
«اللسان»، وبّختني بنعومة.
قلت للجنين: «آسف، يا حبّة الفول الصغيرة. قصدي أقول مؤخرتي».
قالت هانا وهي تقلّب عينيها: «وكنتُ أفكّر ليش عمرك ما جبت بنت على البيت…»
«كلهم مرعوبين من سعيي المحموم نحو التميّز»، قلت بجدية مصطنعة قبل أن أبتسم لها بتعب. «بس عن جد، أظنّي راح أنام بدري. شكرًا على كل حال».
تنهدت هانا وأعادت الإبريق إلى الموقد. رفعت الفنجان إلى وجهها وراحت تراقبني من فوق الحافة.
أدرت وجهي بعيدًا. لم أُرد أن أخاطر بمشاهدة الشفقة في عينيها.
قالت بصوت خافت: «لا تظلّ زعلان من سيث. أنت تعرف إن اللي يقوله نابع من محبة».
كنت قد بدأت أستدير لأغادر، لكنني توقفت لأسمعها.
«حتى لو كان كلامه يطلع قاسي وفَجّ، هو فعلًا يهتم. هو بس ما يعرف كيف يعبّر. ما يعرف أبدًا إيش يقول. أنت تعرف كيف يكون مع المشاعر».
ابتسمت، وعيناها سرحتا في مكان آخر. «أقصد، بالله عليك، قدّم لي الخِطبة برومانسية تشبه محاولة لبس جورب». زفرت بهزّة من رأسها. «عمره ما كان رجل كلام أو مشاعر، يا تورين. أنت تعرف هذا».
كنت أريد أن أسألها لماذا الكل مستعدّ أن يخبرني بما يشعر به أخي، إلا سيث نفسه، لكنني لم أستطع أن أجرّ نفسي إلى جدال معها. فاكتفيت بأن قلت ببساطة: «أيوه».
«طيب، إذا ما راح تاكل، على الأقل روح استحمّ». قطبت أنفها. «ما أعرف كيف قدرت توصل لهالدرجة من القرف في الريحة».
«بالمثابرة والجهد المتواصل»، قلت بجفاف، رافعًا قبضتي في الهواء. «تصبحي على خير يا هانا».
«وأنت من أهله»، قالت في فنجانها.
خرخرة مايلو المنخفضة ملأت المطبخ وأنا أتجه إلى غرفتي. وضعت يدي على مقبض الباب، مترددًا، ورفعت نظري إلى باب غرفة سيث وهانا المغلق في آخر الردهة.
صوت سيث دوّى في رأسي: ما كان لازم تحط نفسك في هذا الموقف من الأساس.
اشتدّت قبضتي على المقبض.
ثم جاء صوت كولتِر، مضادًا: هذه فرصة مثالية لاختبار عزيمتك. انظر إلى الموت مباشرة. أثبت للجميع—وخاصة لنفسك—إنك تقدر تحافظ على هدوءك حتى في قلب الجحيم.
كولتِر كان يفهم. أفضل من سيث على الأقل. وكان محقًّا.
دفعت الباب إلى الداخل بعنف، وأغلقته خلفي. قبل أن أتجه إلى الحمام لأتنظف، جلست أمام مكتبي الصغير وفتحت دفتري.
كان مليئًا بالملاحظات والخربشات: صيغ للمذيبات المنظِّفة، تصاميم لتحسين الدروع والأسلحة، رسومات لبارابِيست، ومئة فكرة أخرى لم أختبرها بعد.
بدل أن أشعر بالإنجاز، لم أرَ سوى ردّة فعل الناس عندما يكتشفون أن المطوّر خلف هذه الأفكار لا يستطيع حتى تسخير الرادن اللازم لاستعمالها.
لكنني رفضت أن أُعرَّف بنقص رادن. لم يهم أنني لا أتوهّج بالإشعاع، أو أنني لن أنمو يومًا بما يكفي لأنظر إليهم مباشرة في أعينهم. عندما أنتهي، سيرونني.

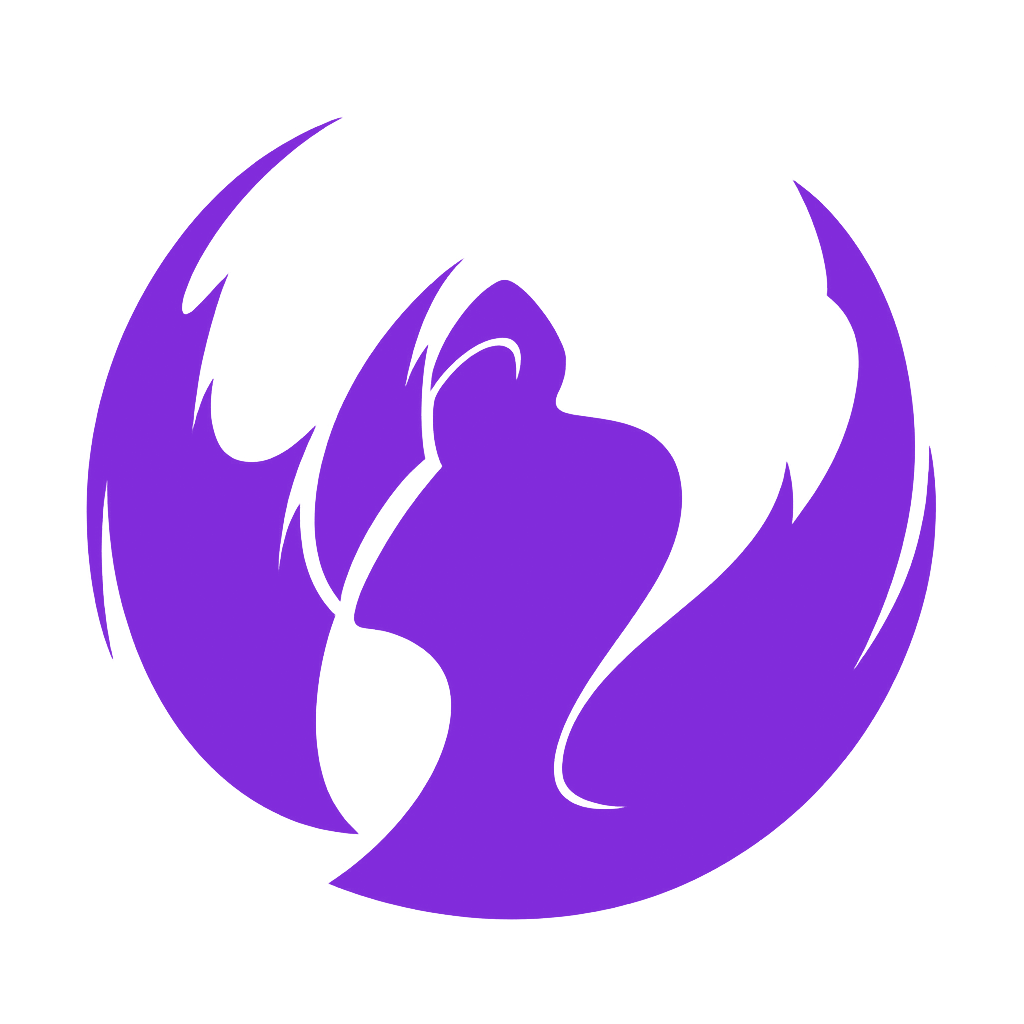




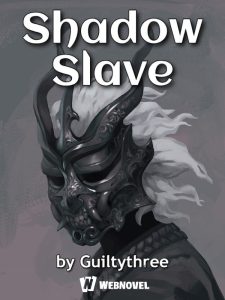









تعليق